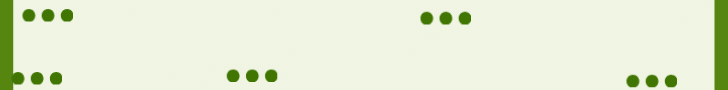بعيداً عن صخب الحياة.

كنت أعتقد أن العبارة الشهيرة التي كانت تُطرح في عقود سابقة بصيغة سؤال: “هل الفن للفن أم الفن للحياة؟” قد انتهت واندثرت في خضم هذا العصر الذي شهد تصاعد الفردانية بفعل الإنجازات التقنية غير المسبوقة. ومع ذلك، أحيانًا أجد نفسي أقرأ نقاشات على بعض وسائل التواصل الاجتماعي تتحول إلى معارك سجالية، وكأن المشاركين فيها لم يغادروا بعد أجواء الحرب الثقافية الباردة التي كانت جزءًا من الصراع بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي. من المهم أن نلاحظ أن كلمة “الفن” في هذا التساؤل الإشكالي تشمل جميع أشكال الإبداع، سواء كانت كتابة (تخييلية أو غير تخييلية) أو شعرًا أو فنونًا تشكيلية. أرى أن هذا التساؤل يعاني من خلل في أساسه المفاهيمي، لأنه يخفي رغبة ضمنية في تأكيد قناعة سابقة سعى المعسكر الاشتراكي إلى ترسيخها، وهي أن الشيوعية تتماشى مع تطلعات الإنسان، على عكس الرأسمالية التي تعزز فردانيته وجشعه ونزوعه الشخصي.
لقد علمتنا تجارب عديدة أن التبني الأيديولوجي لنموذج معين والترويج له ضمن معايير محددة للإنتاج الأدبي يؤديان إلى نتائج أدبية رديئة. ولا أحتاج إلى تقديم أمثلة على أعمال كُتبت في إطار “الواقعية الاشتراكية” وكانت تفتقر إلى الجودة. ما سأعمل عليه في الفقرات القادمة هو محاولة تحليل الأسس الفلسفية التي تحفز الإبداع في مجال الأدب بشكل خاص، رغم أن هذه التحليلات يمكن أن تُطبق على جميع أشكال الإبداع الفني.
الحياة مليئة بالتحديات رغم كل المتع المتاحة فيها، وأصبحت تجاربنا في الحياة تتطلب جهداً أكبر مع تعقيد الحياة وتطورها. إذا قارنت نفسك بأفلاطون، ستجد أنه يمكنك اليوم اكتساب خبرات تقنية تفوق ما عرفه هو وكل فلاسفة الإغريق. لكن هل يمكننا كتابة حوار فلسفي مثل “المأدبة” يتماشى مع متطلبات القرن الحادي والعشرين؟ أشك في ذلك بشدة، فالإلهاءات في حياتنا أصبحت كثيرة، مما يجعل من الصعب متابعة القضايا الوجودية الأساسية ووضعها في إطار فلسفي مناسب كما فعل أفلاطون. قد يتساءل البعض: لماذا لا نحد من هذه الإلهاءات ونعيش بعيداً عنها لنتمكن من تطوير الإحساس الفلسفي اللازم لكتابة أفكار أفلاطونية بملابس عصرية؟ لكن هذا يعني بالضرورة العيش في جزيرة نائية.
دعونا نتذكر ما قاله الشاعر اللاهوتي الإنجليزي جون دون: “لا يوجد إنسان يعيش كجزيرة بمفرده”. في غياب هذه الإلهاءات، تبدو الحياة كأنها تأمل مستمر في موضوعات الموت والشيخوخة والنهايات المحتومة للوجود البشري، مما يثير شعورًا مأساويًا. لا توجد حياة بشرية خالية تمامًا من المتعة. عادةً ما تتخذ الإلهاءات شكلين: الشكل الاختياري، الذي نختاره بأنفسنا (مثل اللعب، المشي، السفر، أو التجوال ليلاً في الشوارع المضاءة)، والشكل الذي يتسم بالالتزامات القانونية (مثل الدراسة والعمل). من هذا، نفهم أن الإلهاءات تلعب دورًا مهمًا في إبعادنا عن التفكير العميق في ثنائيات الموت والحياة، والبدايات والنهايات، والطفولة والشيخوخة، بالإضافة إلى مساعدتنا في الحفاظ على زخم متطلبات حياتنا اليومية.
الانغماس في زخم الانشغالات اليومية حتى الغرق فيها ليس بالأمر الجيد، خاصة عندما يصبح عادة نقوم بها دون تفكير أو تأمل. أعتقد أن هناك العديد من الأسباب التي تدفعنا أحيانًا لتجاوز هذه العادة:
أولاً: الانغماس في بحر مشاغل الحياة اليومية يجعلنا نشعر بشكل بديهي أننا كائنات محلية مصيرها الفناء، وجودنا مؤقت، ونتقيد بقوانين الزمان والمكان المحدودتين. قد يكون هذا صحيحًا في الواقع، لكن أحد شروط الحياة الجيدة هو أن نطرق على هذه المحدودية بمطرقة قوية لنكسر القشرة السميكة التي تحيط بنا، حتى وإن كان ذلك على المستوى الذهني. أعتقد أن السعي نحو الكلكامش موجود في كل واحد منا، بغض النظر عن حجمه. العيش دون الاقتراب من المثال الكلكامشي يبدو كأنه حياة مليئة بالملل، ويشعرنا بخسارة الوقت وعبثية تجربة الوجود البشري.
ثانياً: تترافق الإلهاءات اليومية في حياتنا مع مستويات متزايدة من الضوضاء، حتى أصبح الإنسان يُعرف بأنه كائن مُنتج للضوضاء. اليوم، نتحدث عن البصمة الكربونية لكل فرد منا، والتي تعكس كمية الغازات الضارة التي نُطلقها في الهواء. وأعتقد أنه من المناسب أيضاً مناقشة البصمة الضوضائية للفرد: ما مقدار الضوضاء التي تُحدثها في محيطك؟
نحن كائنات تُحدث الضوضاء بدافع الحاجة أو التسلية أو الملل. نصنع الضوضاء بطرق مختلفة وبدرجات متفاوتة. هناك دراسات متخصصة وعميقة في علم النفس التطوري تؤكد أن البصمة الضوضائية يمكن أن تكون مقياساً تطورياً للأفراد. كلما زادت البصمة الضوضائية لشخص ما، كانت قدراته العقلية والتخييلية أقل مقارنةً بأقرانه ذوي البصمة الضوضائية المنخفضة. ربما يكون التفسير الأقرب لهذه النتيجة هو أن من يتحدث أكثر يفكر أقل.
ثالثاً: يعتمد هذا التسويغ على مقاربة غير تقليدية تستند إلى ما يُعرف بمبرهنة غودل في اللااكتمال، وهي مبرهنة مشهورة في مجالات علوم الحاسوب والرياضيات، وتعتبر أيضاً رؤية فلسفية يمكن تعميمها، وهو ما سأقوم به هنا. جوهر هذه المبرهنة هو أنه لا يمكنك إثبات صحة نظام شكلي من خلال الاعتماد فقط على العبارات الموجودة ضمن نطاق ذلك النظام. لا بد أن يحدث خطأ ما في مكان ما. يبدو لي أن تعميم هذا المفهوم على الحياة اليومية ممكن: لن تتمكن من عيش حياة جيدة إذا اكتفيت بالقوانين السائدة والمعروفة. يجب أن تكون هناك نوافذ إضافية تتيح لك تحسين نمط حياتك، وهذه النوافذ بطبيعتها تحمل طابعاً ميتافيزيقياً يتجاوز الواقع اليومي.
رابعاً: شهدت الحياة اليومية نمواً مستمراً في مستويات العقلنة، حتى اقتربت من حدود العقلنة الصارمة التي تحكمها خوارزميات حاسوبية. من المؤكد أن العقلنة ضرورية في الحياة؛ لكننا نرغب في كبح هيمنة قوانين هذه العقلنة والتفكير في مجالات غير عقلانية. هنا، تعني اللاعقلنة عدم اليقين المسبق بما سيحدث، في انتظار مكافأة الدهشة والمفاجأة بدلاً من الاعتماد على الحدس الممل الذي يقتصر على إمكانية واحدة للتحقق.
خامساً: يرتبط العيش اليومي عادة بمستويات مرتفعة من الأزمات العقلية والنفسية. فعندما لا تكون مضطراً للعيش بمفردك، فإنك تتفاعل مع الآخرين، وهذه التفاعلات قد تكون هادئة أو مشحونة بالصراعات الوجودية. ولا يوجد ترياق لهذا النوع من الصراع إلا من خلال الكتابة، التي تتحول إلى مصادر إبداعية أساسية للكاتب. وقد أشار العديد من الكتّاب إلى أن الكتابة أصبحت بالنسبة لهم كتناول حبة يومية لضبط ضغط الدم. وهم يعبرون عن ذلك بصدق. فبدون الكتابة، يصبحون أقرب إلى كائنات تعاني من الشيزوفرينيا، يكاد الألم والعذاب يفتك بهم.
الأدب الجيد، بجميع أشكاله، هو بمثابة ترياق فعّال لمواجهة التحديات السلبية المرتبطة بوجودنا البشري. يحررنا الفن الإبداعي، الذي لا يقيد نفسه بأطر الأيديولوجيا، من ضيق محليتنا وحدود الزمان والمكان، ويشعل فينا الرغبة الكلكامشية في السعي نحو خلود افتراضي نعلم أنه لن يتحقق. كما أنه يخفف من تأثير الملهيات اليومية، ولو لفترة محدودة، ويحد من ضجيج الحياة، مما يجعلنا نستمع بشغف إلى أصوات أعماقنا التي تخنقها الانشغالات الروتينية. يفتح لنا الفن نوافذ ميتافيزيقية تتيح لنا استكشاف عوالم خيالية لا يمكننا الوصول إليها دون دعم الإبداع الفني. وفي النهاية، يجعلنا هذا الإبداع ندرك أهمية التوازن الدقيق بين العقلانية واللاعقلانية في حياتنا.
تؤدي هذه المقايسات إلى نتائج مذهلة أحيانًا وغير متوقعة، وقد تساهم في الإجابة عن بعض تساؤلاتنا الملحة. على سبيل المثال: لماذا تتمتع الأعمال الأدبية والفلسفية الإغريقية بصفة الراهنية والاستمرارية في التأثير، متفوقةً على العديد من نظيراتها المعاصرة؟ يبدو أن الفلاسفة والأدباء الإغريق كانوا أقل عرضة للتشتت بسبب طبيعة وحجم الإلهاءات المحيطة بهم، مما جعل مقارباتهم أكثر تناغمًا مع تطلعات الإنسان وقلقه الوجودي. في المقابل، تغرق الأعمال المعاصرة في تفاصيل جزئية ذات طابع تقني، حيث تركز بشكل عام على تقديم المعرفة التقنية في مجالات دقيقة، بدلاً من التأكيد على الرؤية الإنسانية الشاملة.
أعتقد أن استكشاف الأعمال الأدبية العظيمة يمثل تجربة ممتعة للغاية، حيث يمكننا أن نلاحظ مدى توافق سياقاتها مع معايير الإبداع التي ذكرتها سابقًا. وسنكتشف أن هذه الأعمال لم تكن محكومة بنظام آيديولوجي معين، إلا إذا اعتبرنا أن الإنسان يستحق أن يكون في مرتبة أعلى من أي اعتبارات آيديولوجية أخرى. كما أنها ساعدتنا على الابتعاد عن الانشغالات اليومية الروتينية، وفتحت لنا نافذة على عمق الوجود البشري، وأنقذت لنا من زخم الصراعات اليومية.
الفن هو وسيلة للفرد الذي يعرف كيف يستخدمه لتحسين حياته اليومية، ومن ثم تحويله إلى تجربة جماعية مثمرة. قد يكون كل ما نحتاجه لصنع أدب جيد هو حاسوب، وكوب من الشاي أو القهوة، ووجبة بسيطة، في مكان بعيد عن ضوضاء العالم لفترة من الزمن نخصصها بعيداً عن زحمة مشاغلنا اليومية. وقبل كل شيء، نحتاج إلى هذه اللحظات لنعيش حياة طيبة، حيث يبدو أن الكثيرين يغادرون هذه الحياة دون أن يتذوقوا حتى جزءاً يسيراً من لذتها العظيمة.
![]()