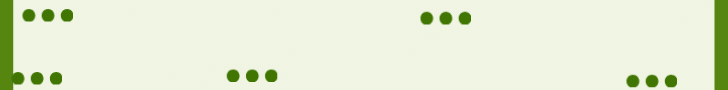أثار المفكر البارز أنور عبد الملك في عام 1962 موضوعًا بالغ الأهمية يتعلق بأزمة الاستشراق. لم يتناول أنور عبد الملك مفهوم الاستشراق من منظورين، معرفي وسياسي، كما فعلت في كتابي “الاستشراق في الفكر العربي” عام 1993، بل كان مهتمًا بالأزمة التي رافقت ظهور الحركة كظاهرة معرفية، والتي سرعان ما تداخلت مع مصالح الاستعمار. وقد أشار الباحث والعالم الاجتماعي المصري المقيم في باريس آنذاك إلى العائلات الفيلولوجية التي ساهمت المدارس الاستشراقية في تعزيزها، والتي قامت على أساس تقسيم العالم إلى فئتين: آري وسامي، حيث تشمل العرب واليهود وغيرهم من الملونين. كان هذا التوزيع بمثابة تبرير للاستعمار، يعمل على وجهين:
إذا كان نابليون يرغب في السيطرة على مصر قبل إنجلترا، كان عليه أن يدعي أمرين: الأول هو أنه مسلم وقد أسلم بحضور علماء مسلمين في القاهرة، والثاني هو أن مصر، كونها تقع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، تعود لفرنسا وليس لإنجلترا في سياق التوزيع الاستعماري. لذلك، كان فريقه من العلماء والباحثين يعمل على إعداد “وصف مصر”، وهو مجلد ضخم يتضمن مقدمة تشير إلى ضرورة تجاوز مصر لقرون من “إسلاميتها” لتعود إلى الحضارة المتوسطية – الفرنسية. وقد جذبت هذه المقدمة بعض المثقفين العرب، مثل طه حسين. بينما لم يتناول عبد الملك هذا الموضوع، ولم يتطرق إليه المفكر الراحل إدوارد سعيد. كان إدوارد سعيد مهتمًا بالمكونات المعرفية لحركة تمييزية تدعي المعرفة بالشرق، وبالأخص الشرق الأوسط والعرب والمسلمين، قبل أن ينتقل مفهوم “الشرق” إلى جنوب شرق آسيا. الشرق الأوسط، كما يراه الدارس التقليدي ورحالة الإمبراطوريات الناهضة، هو ما كان يعنيه سعيد؛ أي أنه يتناول مجموعة من الانطباعات السطحية التي تصور سكان كتل بشرية كبيرة على أنهم كسالى ومخدرون، ثابتون على فكرة واحدة، ولا أمل في تغييرهم إلا من خلال تدخل أوروبي يديره الرجل الأبيض.
من المفارقات التي لم يتطرق إليها الراحل العظيم أن الباحث الإنجليزي المعروف صاموئيل جونسن، الذي أنشأ أول قاموس إنجليزي شامل، جعل من شخصية “عملاق” الشاعر تعبر عن فكرة أن “إيثوبيا” الشرقية، مثل جيرانها، تحتاج إلى رعاية “استعمار” أوروبي “شمالي” لتتمكن من الخروج من عزلتها وجنوبيتها. فقد كان العالم منذ العصور الوسطى مقسماً إلى شمال وجنوب، حيث كان للتوزيع الجغرافي تأثيره على الأديان والشعوب. وقد عرض بعض “التنويريين” في القرن الثامن عشر هذه الشعوب على أنها تعاني من سبات لا أمل في الخروج منه دون تدخل الرجل الأبيض الأوروبي. هكذا كان التفكير “التنويري” الأوروبي. ومن المهم أن نلاحظ أن صاموئيل جونسن كان من أبرز الشخصيات في الحركة “الإنسانوية”، التي تميزت بمعارضتها للعبودية والاستعباد. وإذا كان جونسن يميل إلى هذا المعتقد، فكيف يمكننا أن نتوقع غير ذلك من الآخرين؟ كما يجب أن نتذكر أن جونسن اطلع على ترجمات الباحث البارز في الاستشراق سير وليم جونز وكتاباته، حيث أطلق عليه لقب “جونز الشرقي” Oriental Jones، نظراً لانغماسه في دراسة أدب العرب والفرس.
ترجماته وكتاباته معروفة ولها تأثير كبير. وهو نفسه – أي جونز – الذي في نهاية حياته، وعند مراجعة تجربته ورصده لهذا الانغماس، يستنتج أن ثقافته الأصلية أهم من كل ما قضى عمره في دراسته.
لم يتناول الراحل سعيد هذا الموضوع لأنه كان مشغولاً بمجموعة من التهيؤات والتصورات التي وضعها عدد كبير من الرحالة والكتّاب، الذين كانوا يرون الشرق كمنطقة رثة وساكنة، تفتقر إلى الفكر والمستقبل دون التأثير الإمبراطوري. وأود أن أضيف أن هؤلاء الأشخاص يكملون ما بدأه دانيل دفو في روايته الشهيرة “روبنسون كروسو”، التي صدرت عام 1703، حيث يصور الشرق وأفريقيا كأراضٍ قاحلة يسكنها كروسو، الذي يقوم بتعليم فرايدي الأسود الطريد لغته التي تبدأ بالاستسلام، أي بكلمة “نعم”. وفي النهاية، نجد أن أرنست رينان سيستند إلى هذا التراكم، ويستعمر بدوره نتاج “دي ساسي” ليعيد استخدامه في توزيع العالم وفقاً لمفاهيم آري – سامي، دون أن يأخذ في اعتباره الفروق بين الشمال والجنوب، المستعمر والمستعمر.
كان لديه اهتمام بالتوزيع المتناقض بين مفهوم الآري المتماسك تركيبياً وعقلانياً وحضارياً، ومفهوم السامي الراكد والسكوني. ومع ذلك، واجهت نظرية أرنست رينان، التي كانت سائدة في ذلك الوقت، تحديات مع نهاية القرن التاسع عشر. وكانت النتيجة النهائية لهذه النظرية في مجال الديمقراطية الانتخابية أنها أفسحت المجال للهجرات والأقليات، وخاصة الأقلية اليهودية النشطة القادمة من ألمانيا، التي تأثرت بنظرية العرق الجرماني التي تدعو إلى الوحدة والتكامل على أساس نقاوة العرق. هذه النظرية، التي سيسخر منها المثقف العراقي المظلوم ذو النون أيوب في روايته “الدكتور إبراهيم”، تمثل بذور الفكر النازي. وإذا كان يهود أوروبا من الكتّاب ورجال الأعمال يفضلون الهجرة إلى إنجلترا وفرنسا هرباً من ألمانيا منذ نهاية القرن التاسع عشر، فإن النتيجة كانت أنه لا يمكن الاعتماد على نظرية أرنست رينان وتوزيعها العرقي والديني بين الآري والسامي.
نتج عن ذلك تقسيم واضح بين التوزيع الأوروبي أو الغربي والشرقي. ومن المثير للسخرية أن اللغة النازية العرقية أصبحت جزءًا أساسيًا من لغة المستعمر الجديد، الذي يستخدم مصطلح “حيوانات بشرية” للإشارة إلى العرب، وخاصة الفلسطينيين، كما يتضح من خطب المستعمرين الاستيطانيين اليوم.
عندما ألقى العالم الراحل ياروسلاف ستيتكيفتش محاضرته المبكرة في كلية سينث أنتوني بجامعة أكسفورد عام 1967، كان يشير إلى مسألة قد تبدو غير مرتبطة بما نتحدث عنه؛ حيث انتقد “نحن المستشرقين” لدراستهم الشرق كموضوع دون أن يشعروا بالانتماء إليه بحب وتعاطف. كان يوجه اللوم إليهم لأنهم يكتبون ويقرؤون باللغات التي يدرسونها، لكنهم يفتقرون إلى القدرة على استخدامها في التواصل والعلاقة مع العرب، الذين هم موضوع دراستهم. كان يدعو بإصرار إلى ضرورة وجود حب حقيقي، وليس مجرد دراسة أكاديمية، لكي يشعروا بالانتماء إلى ما يدرسون. ولهذا السبب، عجزوا عن إقامة علاقة حقيقية مع موضوعهم، أي العرب.
من بين هؤلاء كان المستشرق مرغليوث، الذي قام بجمع أحاديث التنوخي ورسائل أبي العلاء المعري. لكنه أيضاً كان جزءاً من البعثة البريطانية التي احتلت العراق. ويشير الشاعر والباحث محمد مهدي البصير، الذي عاصر تلك الفترة، إلى أن مرغليوث قال أثناء التفاوض مع الوفد الوطني العراقي: “لم ألاحظ أن العراقيين يمتلكون القدرة على إدارة شؤونهم”، مما يعني أنهم بحاجة إلى الاستعمار البريطاني أو غيره!
تعتبر هذه نهاية الاستشراق، وهي ليست نهاية معرفية فحسب، بل تحمل أيضاً أبعاداً سياسية، إذ ترتبط بالتباينات العرقية التي رافقتها وأدت بها إلى هذه النهاية. لا يعني ذلك التقليل من الإنجازات المعرفية التي حققها شخصيات مثل السير وليم جونز ودي ساسي وسير شارلز لايل وغيرهم. لكن إشارة الراحل ياروسلاف إلى أهمية التواصل ودوره في تعزيز حب حقيقي لموضوع الدراسة تشير ضمنياً إلى ضرورة الابتعاد عن عقدة المستعمر، أي الادعاء بالسيادة على الشعوب الأخرى. ولهذا، انحدر الاستشراق نحو نهايته مع ازدهار العلوم الاجتماعية وظهور المستعرب كشريك ثقافي. ومع ذلك، فإن هذه هي بداية المستعرب الذي درس العرب من زوايا متعددة، وجاء بدوافع قائمة على الحب والمودة لموضوع الدراسة. فالمستعرب ليس مجرد دارس للأدب فحسب، بل يتجاوز ذلك.
يمكن أن يكون الشخص مؤرخاً وسوسيولوجياً وفيلسوفاً وغير ذلك، فهو ينتمي إلى الثقافة التي يهتم بها، حيث لا يوجد تمييز بينه وبين أفراد تلك الثقافة، لأن كلاهما يبذل جهداً وتمعناً متساويين. لنعد إلى السؤال: ما الذي تبقى من الاستشراق؟ لا يمكن تجاهل الإرث الواسع الذي تركه المستشرقون في مجال الترجمة والفيلولوجيا، لكن التقليديين منهم الذين اتبعوا نهج مرغليوث لم يحققوا سوى إنجازات محدودة، مقارنة بالجهود التي يبذلها المستعربون والمستعربات، الذين يمتلكون أدوات بحث وتحليل حديثة. هؤلاء لا يقللون من قيمة معرفتهم بالثقافات المتنوعة والاختلافات التي تميزها عن “النمطية” الأوروبية، ولا يتبنون النظرة الاستنكارية تجاه الآخر لمجرد اختلافه عن التصور “التقليدي” الذي يعتبر نمطاً وحيداً وعقلانياً قادراً على إدارة الآخرين.
![]()